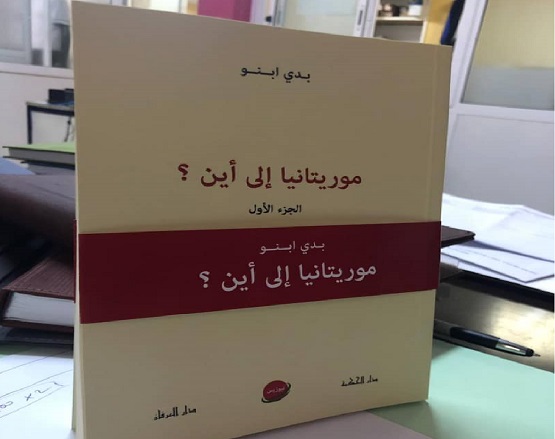كتاب: “موريتانيا إلى أين؟” للباحث د.بدي أبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.
الحلقة الخامسة عشرة: الهــزّات الصـامتة
مع انفجار عدد السكان وتمديُنِهم واحتكاكهم في صيغ غير تقليدية، نمتْ أنماطٌ من التعارف والعلاقات هزّت إلى حدٍّ ما منظومة القرابات التقليدية ولكنّها لم تخلق بعدُ لدى الأجيال الجديدة معنى مستقلا للجوار التساكني وللفضاء المديني
ونجحتْ جزئيا هذه الأنماط في اختراق الحدود الأفقية في مستوى الفئات المتشابهة، ولكنها لم تخترق بنسبة ملموسة بعدُ الحدودَ الشرائحية والعمودية الهرمية، ولم تتجاوز الحواجز الثقافية العرقية حتى في إطار مستويات هرمية يُفترض تقاربها.
ويعني ذلك أن هذا التحول رغم ثخونته ظلَّ في أجزاء كبيرة منه كُمونيّاً، ولما يُـقُـدَّر له بعدُ الخروج الفاعل إلى العلن. ويعود ذلك في أقوى جوانبه إلى عامـــــلين متداخــــــــلين ومحوريَّين: أحدهما أنه إذا كانت الحياة العملية المدينية أوشبه المدينية طيــــــــــــــلة فترة الطفــــــــــــولة
والمراهقة لا تستنفر المرجعيات التقليدية في تفاصيلها العملية إلا عَرَضاً، فإن الأمر ينعكس مع الدخول في الحياة العملية أو التأهب لها بعد فترة تعلّم وتكوين أو بدونها؛ فالفضاء المدني مرتبط في نجاعته بعلاقته بدولة مدنية غائبة.
والمجتمع التقليدي المحدث في ظلّ تتويج دولة الامتيازات هو الذي كاد أن يحتكر في العقود الأخيرة كل المهمات التي تُفترض إناطتُها بالدولة. ففي الدولة الفوقية، وفيما يتجاوز المنطوق إلى المفعول، يكون الريعُ العمومي وكلُّ مشتقاته امتيازا يمرّ عبر القنوات المخولة بالطرق الضمنية لا المكتوبة. والخدمات العامة من تربية وصحة وتوظيف وضمان اجتماعي وحتى من أمن تظلّ إلى حدّ ما امتيازات أكثر ممّا هي حقوق.
أما العامل الثاني الذي يشكّل استمرارا للأول فهو أن البطالة، الصريحة والمقنّعة معا، التي تطال أغلبية القوى الحية المنحدرة من أجيال ما بعد “الاستقلال” تنعكس على الأخيرة في شكل أزمة انتماء وهوية. يتمُّ انزياح هذه الأجيال شيئا فشيئا نحو عظاميتها أي نحو فضاء الانتماءات “التقليدية” كملاذ قيمي. أو بتعبير آخر، من لا يجد وسيلةً لتحقيق ذاته بمهنة أيا كانت، كمهندس أو كأستاذ أو كعامل، لاسيما إذا امتلك كل مؤهلاتها، يصبح تلقائيا “مضطرا” للجوء إلى انتمائه القبلي أو الشرائحي أو العرقي للتزود بمكانة اجتماعية تعويضية. تتوارى صفة مواطنية المواطن لصالح صفة فلان الفلاني.
فأمام انتفاء حقوقٍ مواطنيةٍ تتجه إلى الفردِ بشكلٍ مستقلٍ عن هويته الجزئية أو انتمائه التقليدي، تتجهُ إليه بصفته مواطنا أي كعنصر تكويني للكيان الجماعي السياسي وفي ظل بطش السلطة وحالة العوز بل البؤس المستديم يحتلُّ شحن الهويات الجزئية وتعبئتها كبؤر امتيازات موقعَ الوسيط الأكثر جاذبية ونفعية في التعامل مع الدولة – النظام. بل يصبح بعث الانتماءات العتيقة، وإعادة توظيف رموزيتها لخلق مرجعيات “تقليدية” محدَثة، الأداةَ بل رأسَ المال الأكثرَ مردودية.
هذه الظاهرة الجدلية هي في قلب ما يمكن أن نسميه البلبلة المعيارية والوعيَ المحجَّب أو لنقل الوعي المطاطي المتأرجح والمتقلب الذي يجد ترجمتَه في كمّ لا حصر له من التصرفات التي تبدو على مستوى الشكل في قمة التناقض. فتظهر لدى نفس الفرد الرغبات الأكثر تضاربا في الانخراط في العصر وفي الاغتراب عنه وبالأشكال الأكثر ابتذالا وخواء. وينجم عنها استبطانٌ لدى الأجيال الجديدة لثنائية الخشبة والكواليس الدولتية، أي لازدواجية وكلاء الدولة الذين يجمعون بين الشكليات “الخارجية” والحقائق المحلية، بين المعايير المعلنة والمعايير الفعلية.
غير أنّ ما يُضعف قوّةَ شحنِ الانتماءات التقليدية هو أن هذا الشحن بالذات يُطعّمها بدلالات جديدة تدفع شيئا فشيئا نحو تفكّكها الذاتي. أو بمعنى آخر فإنه يُفْقدها جزءا كبيرا من رصيدها الرمزي والقيمي أمام توظيفها الأداتي وتبضيعها أو تحويلها التدريجي إلى سلعة محضة بتأثير مناخ العوز الذي تضاعف طيلة العقود الماضية، وظلَّ إلى الآن يتزايد طرديا مع تزايد وتنوع الحاجيات وتنامي وتوسع الفقر، بما يخلقه استمرارُ ذلك لفترات طويلة من هشاشة في العلاقات والأوضاع ومن تضخم أحاسيس التخوف اليومي أو مشاعر الريبة والاحتراز الاجتماعيين.
صحيح أن لذلك انعكاسات بالغة السوء، إذ أنه يُضعف المحتوى الأخلاقي للعلاقات الاجتماعية بإخضاعها للتبضيع والسلعية، ويمنح بذلك – في ظل استحلال الملكية “العمومية” أو هدر ذمة الدولة – قبولا اجتماعيا إضافيا لنهم الفئات المتنفذة والمستفيدة من ريع الدولة الفوقية عبر إضعافه – وأحيانا إلغائه – لكلّ مستويات الحرص الاجتماعي على نقاء الطرق المتبعة في الكسب والتحصيل.
وصحيح كذلك أنه يقوي الزبونية تجاه الدولة وتجاه المجتمع “التقليدي” المؤدول، أيْ أنه يشارك في التعميم المتفاقم والشامل لتدوير الفساد الملازم للريع الامتيازي. ولكنّ تحويل الانتماءات إلى علاقات زبونية يهدم أسسها ويجعلها قابلة للإنقلاب الفجائي.
إلى ذلك فإن طردية تزايد وتنوع الحاجيات وتنامي وتوسّع الفقر في العقود الأخيرة قد طالت الحلقات الأكثر اقترابا من الفئات المتنفذة وألحقتْ أغلب شرائح البرجوازية الصغيرة التي كانت تنمو في هامش المؤسسات الناشئة للدولة بالفئات المعوزة وبمناخها.
وهو ما أوهن عمْقيا في نفس الوقت الولاءات التقليدية وولاءات موكَّلي ومواكلي السلطة وإن لم ينعكس ذلك بعد كثيرا على سطح العلاقات الزبونية. ولكنَّ تقصِّي مستوى الروابط والوِصايات ينبئ بسهولة عن واقع ثخين يختمر خلف البنيات المنظورة وينبئ أنّ تمفصلات جدّية قد تشكلتْ.
وبالرغم مما يشاهد لدى الأجيال الجديدة من ترسّخ للمرجعيات التقليدية بشكل يفوق حتى أقرانَهم من الأجيال القديمة بسبب العاملين الذين عرضاَ لنا فلمْ يَعد يخفى حضور مرجعيات مدنية أو على الأقل مدينية منافِسة.
وهناك توق جارف إلى تَمثّل العصر له محتواه مهما كانت ترجماته الحالية ساذجة ومرتبطة بالثقافة السلعية والاستهلاكية السائدة. فهنالك فضاء ما يتشكل ويعرف توسعا مستمرا ويحمل نسقا دلاليا مختلفا، وهو يحمل معه منظمومة معيارية وقيمية قيد التبلور.
وقد أدى العامل المزدوج للانفجار الديمغرافي ولانخفاض أمل الحياة إلى تجدّد متلاحق للأجيال. وغني عن القول إن هذا التجدد ترافق – للأسباب الداخلية والخارجية المعروفة – مع هزّات نزوحية وطفرات من التقري والتمديُن طالتْ بنِسبٍ متفاوتة معظمَ إنْ لم يكن كلَّ شرائح المجتمع.
ومن ثمّ، ففئات واسعة من الأجيال الجديدة قد نمتْ وتكونتْ ذهنيا في الساحات شبه المختلطة أو نصف المختلطة للمدن أو للتجمعات السكنية التمازجية، للحجرات الدراسية أو شبه الدراسية وللملعب وما في معناه.
نمتْ وتكونتْ ذهنياً تحتَ تأثير الطفرات الإعلامية المتلاحقة بدءا بالصحيفة المقروءة والمصورة والإذاعة والتلفزيون، وصولا إلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي الأنترنتية الرائجة.
وكما تمرّستْ هذه الفئات بمستويات متفاوتة من التعاطي التداولي العلني بدل التعاطي الضمني التقليدي. وتأثرتْ بالمرجعيات شبه المدنية بشكل يوازي – إن لم ينافس – تأثَّرها القوي بالفضاء التقليدي المعزول أو الجزئي وبمرجعياته. كما أدّتْ الهجرة العمالية وغير العمالية لعشرات الآلاف من الشباب في العقود الأخيرة إلى تقوية موقعهم الاقتصادي والرمزي كمصدر دخْلٍ لفئات متزايدة. وكما أكسبهم تموقعًا محلّيًا متزاوجاً مع تمرسٍ “بالعصر” وطموحٍ لامتلاك زمامه ولتبيئته محلياً.
ولكن هذه الطفرات الضخمة ما تزال مطمورة خلف البنيات الاجتماعية والأنثروبولوجية المستنفرَة والمستثمرَة سياسيا. ومع أنه من المستبعد أن تحدُثَ طفرات كهذه دون أن تهزَّ بقوة البنيات الاجتماعية القائمة وأن تهزّ معها ترجماتها السياسية فإن الخطاب العمومي السائد ما يزال يبدو وكأنّه وفيٌ للغته العتيقة، ما يزال يبدو وكأنّه يفتـَرض وهو يستعيد مفرداته كما هي أن الوضع القائم هو بالضرورة وضع قائم، أيْ يكرّس وهْمَ سرْمدية الوضع الموروث عن العقود الأخيرة.